أقلام نسائية فاضت بالدمع على فراق الحبيب.. حكايات الحب والألم
الموت دائمًا الشبح الذي يأتي دون سابق إنذار، هو فقط يأتي حاملًا معه رسالة وداع من أحدهم، رسالة تخبرك أن هناك حبيبًا فارقك دون رجعة
add تابِعني remove_red_eye 1,435
الموت دائمًا هو الشبح الذي يأتي دون سابق إنذار، هو فقط يأتي حاملًا معه رسالة وداع من أحدهم. رسالة تخبرك أن هناك حبيبًا فارقك دون رجعة أو لقاء في هذه الدار، لكن لا أخفيك، إن الموت لا يأتي ويأخذ كل شيء دفعة واحدة وإنما هي مراحل طويلة تبدأ من أول رائحته وشيئًا فشيئًا ينحدر من ابتسامة بصوت حنون وصولًا لصورة قد بهتت من الذاكرة ثم تختفي، حينها فقط ستدرك أنك قد فقدت هذا الإنسان بالفعل، هنا فقط سيندثر الجسد ويختفي ولا يبقى منه سوى قليل من الذكريات.
حامل رسالة وداع الميت قد يكون طبيبًا أو صديقًا، أو حبيبة، صديقًا في الجيش، أو صاحب المشرحة أو ربما رقم الطوارئ، وقد يحالفك الحظ أن يأتي النعي من مذياع المسجد يعلن عن وفاة الحبيب، لكن في كل الأحوال الموت هو الصديق الوحيد الذي لا يختبئ وراء الستار تستطيع التعرف عليه من صوت الرياح أو من رائحة حبات المطر التي امتزجت مع جمرات تسيل من العين لتعلن عن فراق الحبيب الذي ذهب ولن يعود، ولا بد من أن تعتاد على فراقه.
ماذا لو كان حامل رسالة النعي هي الحبيبة، وماذا لو كان الميت أديبًا عالميًّا أو شاعرًا أو فيلسوفًا، هل فكرت يومًا كيف يمكن أن يرثي الحبيب حبيبته، أو الحبيبة فقيدها الذي فارقها. هذه الكلمات التي نستطيع أن نعبر بها عن الفقد كيف يمكن أن تظهر الوفاء والحب؟ هل نحتاج لأن نظهر ضعفنا الآن وفي هذه اللحظة أم تختفي وتحتفظ بقدسية العلاقة مع الحبيب أم تخرج أسوأ ما فيها؟ اختلف الأمر من كاتبة لأخرى، منهم مَن خلد الحبيب في قوة ومنهم من أظهر الضعف ومنهم من كانت رسالته ليست إلا انكارًا للحب، اختلفت الكاتبات، واختلف معهم أيضًا كتاباتهم وأسلوبهم في التعبير عن التخليد كل حمل رسالة الوداع بطريقته.
“احذر من صديقك مرة واحذر من حبيبك ألف مرة”.
رسالة رثاء خُلدت في السماء
(قبل البارحة توفي الدكتور فرانز كافكا في فيينا، الكاتب الألماني الذي عاش في براغ) هكذا بدأت ميلينيا الرثاء الذي كتبته في أوائل يونيو 1924م، الرثاء الذي كتب لأعظم كاتب في القرن العشرين، هنا والآن وبعد أكثر من مائة عام، بات من السهل معرفة من هو كافكا ،في حين أنه لم يكن مشهورًا وقتها، وبات مشهورًا لدينا أكثر الطرفين بعد انتشار كتاب رسائل كافكا إلى ميلينا لكنه عندما مات كان بالكاد قد سمع عنه أي شخص في هذا الوقت، لذلك كان مثيرًا للدهشة ظهور هذا النعي في إحدى الصحف التشيكية فور وفاته.
إن كتابة رثاء عن حبيب كان أضعف من أن يقدم الحب المنتظر منه، يجلب معه رغبة في تصفية الحسابات ولكن ميلينا لم تكن في حاجة لفعل كل هذا فالعاشق لا يتمنى إلا تخليد الحبيب وهذا ما فعلته خلدته بأفضل وأنبل صورة للأجيال القادمة، فقد فسرت في رثائها الجوانب التي تبدو ضعيفة وهشة فيه وحولتها لنقاط قوة، وللحقيقة كان الرثاء خارجًا من أعماق محبة بصدق فقالت (لقد كان وعيه العميق وحكمته المذهلة تجعله هائبًا من الحياة وضعيفًا جدًّا لمواجهتها، كان وعيه بالعالم غير عادي وعميقًا، لقد كان هو بحد ذاته عالمًا ممتلئًا غير عادي وعميقًا).
رسالة رثاء سقَطت إلى بقاع الأرض
وكما أن هناك من خلد الحبيب في أنبل الصور هناك من أسقط الحبيب في الأرض كما فعلت سيمون دي بوفوار مع حبيبها سارتر ،فبعد وفاة سارتر أصدرت سيمون كتابًا بعنوان “وداعا سارتر” وكان كتابًا مثيرًا للدهشة بعد موته فكيف يمكن لأحد أن يكتب كتابًا بهذه القسوة فهو لم يكن كتاب تكريم لصديقها ورفيقها طوال هذه الحياة، فمن منا لا يعرف قصة سيمون وسارتر فهل بعد كل هذه الرحلة الطويلة والرفقة في الفكر الحر والنضال السياسي تكون النهاية صدور كتاب أقرب ما يكون تصفية حساب مع الرجل الذي قضت الجزء من أكبر حياتها معه؟ أو كما يقال ظله الذي لم يفارقه طوال حياته.
قد أرادت سيمون في هذا الكتاب أن تستعيد صورتها واعتبار نفسها كامرأة وكاتبة، فقد قامت بالتحدث في هذا الكتاب عن تفاصيل سارتر، وعيوبه الشخصية، وكأن الأمر لا يظهر سوى شخص حانق على من كان في ظله طوال هذه المدة وليس شريكًا مرافقًا للحياة، فكما يقال القريب منك كثيرًا هو أكثر من ينتقدك في هذه الحياة بعد معرفة نقاط ضعفك قبل قوتك، فقد حرصت على إبراز عيوبه، لكي تقول إن رفقتها الطويلة له لا تعني أنها تجهل تلك العيوب.
وللحقيقة قد أظهرت كثير من العداء والعنف لكل من استنكر عليها هذا الفعل بعد نشرها لهذا الكتاب، وفي حوار لها مع صحيفة عربية حول هذا الكتاب: “لا أدري لماذا كل هذا الهذيان الذي ظهر حول هذا الكتاب في كل مكان، لقد شعرت كما لو أن هناك من يريد أن يدفني، وأنا حية. لقد مات سارتر، وهم يريدون إحياء تقليد هندي قديم بأن أموت إلى جانبه، هؤلاء لا يتحملون صراحتي، يريدون فقط أن أكتب مرثية للفيلسوف الكبير، لكني أرفض أن أفعل، تأخذون عليّ أنني سلطت الضوء على نقاط ضعفه، أهم فصول حياة أي فيلسوف هي تلك التي يظهر فيها ضعفه، الفلسفة ليست تعبيرًا إمبراطوريًّا عن أفكار وجدانية وإنما هي الدخول في عمق الإنسان وهذا ما فعلت”.
“قتلوا حبيبي فنفخت فيه من روح قلمي”.
حرقوا رسائلي واغتالوا حبيبي
هناك أيضا في فلسطين الأرض الخضراء وفي الستينات قد نبتت قصة حب أخري بين الشاعر الفلسطيني غسان كنفاني وغادة السمان، كان دائمًا يعبر لها عن حبه فقد كتب فيها يومًا “ضياعها كارثة بلا أي بديل، وحبي شيء في صلب لحمي ودمي، وغيابها دموع تستحيل معها لعبة الحياة” فكيف يمكن لأنثى أن تسمع هذه الكلمات في حقها ولا تكون سوى عاشقة محبة بصدق، رأت أن الحبيب لا يخلد إلا بنشر رسائله فقد أعطت الحق له كأديب أن يرى العالم كيف كان مبدعًا، وربما بفضلها وفضله كان لأول مرة يتم التعرف على أدب الرسائل في العالم العربي.
فبعد أن توفي غسان على يد الصهيون، شرعت غادة في جمع كل الرسائل والعهود التي كانت بينهما، وأصدرتها في كتاب، نشرته في ذكرى وفاته 1992 وأسمته “رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان” ليبقي أكبر شاهد على هذا الحب، وقد صرحت أنهما قد اتفقا على نشر الرسائل بعد موت أحدهما، وبعيدًا عن كل الشوائب والملابسات والمناقشات حول قصة الحب هذه وحقيقة هذه الرسائل بين العاشقين، لكن لا ننكر أنها كان لها الأثر الكبير في مسيرة الشاعر الكبير كأديب بليغ وعاشق سكران.
اعتدنا دائمًا أن نرى غسان كاتبًا مناضلًا لأجل قضية بلده، فقد كان وطنيًّا وسياسيًّا شرسًا يهاجم كل من يفكر في سرقة قطعة من أرضه، وبهذه الرسائل فقط تمكنا من رؤية الجانب الإنساني لهذا الأديب صاحب القلم الحاد فبِكلماته كان يذبح أي صهيوني، وهنا بكلماته كان قد ذبح كل عاشق، فقد فاضت برسائل بكل المشاعر الرقراقة التي تغنى بها كل العشاق وحتى يومنا هذا فهو الذي كتب لها “إنما شراستك كلها إنما هي لإخفاء قلب هش” وهي التي لا تسقط هنا سوى على هذا المناضل.
قتلوا حبيبي خلف القضبان
وفي نفس المدة تقريبًا في الستينات، ننتقل من فلسطين إلى مصر، وجدت فيها الكثير من الرجال كانوا يرثون حبيباتهم وزوجاتهم ولكن من النساء لم أجد سوى أمينة قطب (أخت سيد قطب) التي رثت زوجها كمال السنانيري في ديوانها “رسائل إلى شهيد” وأهدته إليه بعد وفاته، فقد ذكرت في إهدائها من هذا الديوان: “هذه الرسائل كلها إليك.. كتبتها بعد تلك الليلة، بعد أن غادرت بيتنا ولم تعد، إنها أول رسائل لن تراها ولن تقرأها، ولن تبعث بعدها بردّ. ولكني كتبتها إليك رغم هذا اليقين، فما كنت أمتلك حبس الدموع وأنت ترحل عني بلا عودة”.
الأنثى والزوجة التي عاشت عمرها بين الأقلام والتي اشتهرت بقصيدتها المبكية “هل تُرانا نلتقي” ،فأنّى لها ألا تبدع بعد كل ما رأته من معاناه وعذاب فمن تقبل من البداية بالزواج بمن هو قد حكم عليه بالإعدام لعشرين عامًا، قد يكون هذا ليس شعرًا وقد لا يكون رثاء وقد لا يكون شيئًا لكن في النهاية لا يمكن إنكار أن كل ما هو إبداعي قد تولّد من الألم ،فَالسيدة أمينة لم تكتب وتصور لنا سوى أجزاء من صور التعذيب التي تلقاها أخوها وزوجها من السجن، وعاشت عمرها كزوجة تشارك الزوج فقط الرسائل من أول خطبتها وحتي مقتله، وظلت أيضًا تكتب له بعد وفاته.
من الإبداع أن هذه المشاعر لم تخرج إلا على هيئة شعر في رثاء الحبيب الراحل، فهي تحمل في طياتها من بواعث الحب والإخلاص والوفاء والجهاد والصبر وحسن الظن ما يمر على القلوب فيُرققها، وما يمر على العيون فيُرقرُقها ،وما يمر على العيون فيفتحها على آفاق لم تعرف لها حدودًا فيما تقدم ذكره من مشاعر ،فهي التي كتبت فيه:
ما عدت أنتظر الرجوع ولا مواعيد المساء
ما عدت أحفل بالقطار يعود موفور الرجاء
ما عدت أنتظر المجيء ولا الحديث أو اللقاء
ما عدت أرقب وقع خطوك مقبلًا بعد انتهاء
ما عاد يطرق مسمعي في الصبح صوتك في دعاء
وفي النهاية “إنها دموع الفراق، حتى ألقاك عند ذلك المرتقى”. شريكة الحياة أمينة قطب. هكذا ختمت رسائلها وذرفت دمعها.
“حتى تحترق النجوم وحتى تفنى العوالم يا زوجي“.
سأموت الليلة ياحبيبتي
حين نتذكر الرسائل والكتابات التي أظهرت أضعف لحظات العشاق، إما في لحظات الترجي في الحب أو حتى في لحظات الموت في أحضان الحبيبة، وفي هذا الموقف نتذكر أيضًا “آنا غريغوريفنا” زوجة دستويفسكي التي بعد موته كتبت مذكراتها معه بكل تفاصيلها فهي التي وصاها قبل وفاته “عندما أموت يا آنا، ادفنيني هنا أو أينما تشائين، ولكن تذكري جيدًا، لا تدفنيني في مقبرة “فولكوفوية” ضمن مدافن الأدباء، لا أريد الرقود بين أعدائي، يكفيني أنني عانيت منهم الأمرّين في حياتي”.
وهي التي كتبت عنه في نعيه “وفي التاسعة صباحًا 9 فبراير غفى بهدوء ويدي في يده، إلا أن النزيف أيقظة في الساعة الحادية عشر، والمنزل يغص بالحاضرين في انتظار الطبيب الذي وصل في حوالي الساعة السابعة مساءًا، آنذاك انتفض دوستويفسكي فجأة دون سبب واضح ورفع رأسه فشحب الدم في وجهة من جديد، ولم تسعفه مكعبات الجليد، أغمي عليه وشعرت أن النبض كان يضيع، وفي الثامنة والثلاثين أسلم الروح، وفي الأول من مارس شيع جثمان فيودور دوستويفسكي” وذكرت أن موكب تشيع جثمانه كان أعظم من تشييع جثمان الإمبراطور، فأي زوجة عاشقة كانت لتقدس هذا العظيم الإنساني التي لم تشهد بطرس برغ مثله.
وفي موضع آخر ذكرت أنه قد طلب منها أن تحضر له الإنجيل وتشعل شمعة وأخبرها من وسط إعيائِه “سأموت اليوم”، وهي التي ذكرت لنا في يومياتها عن أول لقاء معه بعد إلقائه عليها أول صفحات كتاب المقامر وظلت تتمنى لقاءه مرة أخرى، ذكرت أنها لأول مرة في حياتها ترى إنسانًا ذكيًّا وطيب القلب إلى هذا الحد، لكنه أيضًا تعِيس بنفس القدر وكان الجميع أشاحُوا بوجوههم عنه، فتألمت وشعَرت بالإشفاق عليه. هذه الحكائية قد أظهرت من ضعفه ومرضه ومعاناته تمردًا ونجاحًا قويًّا فهي التي أوضحت حب الناس له فى دفنه وإعجابها الشديد به من أول لقاء، وذكرت كل تفاصيله ولقاءاته وصداقته ووصفته بالانطوائي الصادق.
أنتِ وطني ومؤنستي
من كان يصدق أن الأجنبية التي اتخذها زوجة له ستكون هي الدرع الذي يحميه من أبناء بلده، فالفتى الذي لم يكن يعشق سوي الأدب والعلم، سيكون له يوما كل هذا العوض والحب، إنها سوزان زوجة طه حسين الفتاة التي تربَّت علي يديه واحتوته وهونت عليه، في الوقت الذي هوجم فيه في قاعدة الدرس بالأزهر فالأديب العالمي الذي لم يحفل أحد يومًا بمواجهة لغته وعباراته بات اليوم مهانًا، فعومل طوال الوقت من بعد عودته لمصر بقسوة شنيعة ولم يجد سوي الحبيبة تحتوي وتضمد الجراح.
وهي التي عاشت لتعالجه في الحياة وهي أيضا التي بعد وفاته عاشت لتُخلد لنا ذكراه في كتاب أسمته “مَعَكَ” سطرته بعد وفاته، إحياء لذكراه التي لم يطوها الموت ولا النسيان، في البداية كتبته بالفرنسية، لكنها أرادت أن يصل أيضا للقارئ العربي، لكي نتعرف أكثر على عميد الأدب، ونتعرف أكثر على المرأة التي كتب له “أنا لا أساوي شيئا بدونك”، وقالت عنه: إنه “على الرغم من الرعاية اللطيفة التي كان يحاط بها، فقد كان مثقلًا بالحزن والوحدة، ويطلبون إليه كتابة أربع مقالات في الأسبوع لكنه يكتب لي”.
وفي اليوم الذي أخبر فيه أنه نال جائزة حقوق الإنسان، وكان ممددًا على سريره ويتحدث مع زوجته وفي الوقت الذي كانت توصيه بالاهتمام بصحته وتناول دوائه، كانوا يتحدثون فسألها في سخرية “أية حماقة؟ هل يمكن أن نجعل من الأعمى قائد سفينة؟”ثم صمت للحظات، وقبل أن يطلب يد زوجته ليقبلها، وتقلبت قليلًا وفي السادسة صباحًا استيقظت سوزان وجعلت أديبنا يشرب القليل من اللبن وأعدت له القهوة، ودنت من سريره وناولته ملعقة من العسل، تناولها وعادت إليه كان قد زَفر آخر أنفاسه”.
فهي هنا لم تعرض ضعف زوجها الضرير ولم تشكو منه، وإنما تحدثت عن الصعاب التي مر بها وكيف تغلب عليها بإصرار وتحدٍّ، أظهرت فقط قوته ومحبته وإيمانه العميق برسالته، إنه لفرق كبير بين أن تقرأ الأيام وبين أن تقرأ “معك” ،فأي مشاعر تلك التي دونت به العاشقة ذكريات دامت أكثر من خمسين عام ذكرت فيه الأصدقاء والأحباب والأولاد دونت فيه تساؤلاته ونقاشاته معها حول الفلسفة والدين والجمال والمسرح والفن، أي حب هذا الذي لم تملّ ولم تتملل منه وإنما ساندته وشددت عضده في الوقت الذي مرّ فيه بكل هذه الصعاب والمعاناة، فهي التي استحضرت الذكريات لكي لا يموت حبيبها، فبَعثته من جديد عبر الذكريات.
فاذكريني كما تذكرين المَهرب
“اطمئن لن أحبك” هكذا قالت الكاتب عبلة الرويني لأمل دنقل بعد أول لقاء لها معه، والذي فيه قد سخر منها ببضع كلمات، لكنها من داخلها كانت تعلم أن هذا اللقاء لن يمر مرور الكرام، فمن منا لن يقع أسير كلمات وفصاحة هذا الشاعر، وبالفعل قد كان، فَعبلة هي زوجة أمل دنقل وحبيبته، وكانت هي المرأة التي أظهرت لنا إبداعه، فكشفت كل أسرارها معه في كتاب أسمته” الجنوبي“، فالشخص الذي بسببه تحاشاها الجميع ورفض عملها وقُطِعت كل مقالاتها واحدًا تلو الآخر كل هذا بسبب علاقة الحب التي كانت بينها وبينه، وكأن القصة تشبه قصة الجميلة والوحش.
لكن في غرفة رقم ثمانية في الدور السابع ،كان يحدث لقاء العاشقيْن بالمستشفى بعد تسعة أشهر من الزواج، فقد أصيب أمل بورم جعل يتزايد في جسده ولم يكن يدري أن السرطان سيكون هو سبب الفراق ،فكأن هذا المرض لم يكفه الفقر والجوع والمعاناة التي يعيشها، أيضا عليه أن يعيش حالة حب تدوم لفترة أكثر، وانتشر المرض في كل جسده، حتى إن الطبيب أخبره “المرض منتشر في جسدك منذ أكثر من سنة، وأنت لا تأتي لمتابعة الكشف، تذكر أنك مريض بالسرطان، وأن الأمر أكثر خطورة من أن تتعامل معه بمنطق الشاعر، لقد تجاوز المرض الجراحة ولا بد من ذهابك في الغد إلى معهد السرطان”.
وهنا فقط تنفجر الحبيبة عبلة في البكاء بينما ظل هذا الأمل بكل شموخ وصمود صامتًا لكن ينهشه الحزن من الداخل، حتى سألها: لماذا لا يريدني الطبيب أن أتعامل مع السرطان كشاعر؟ وهي التي أسمته الجنوبي تيمنًا بآخر كتاباته التي تحمل نفس الاسم، وهي التي كانت قرارًا نهائيًّا منه بالموت، هي التي وصفته في موته “كان هادئًا وهم يغلقون عينيه، وكان هدوئي مستحيلًا وأنا أفتح عيني، وحده السرطان كان يصرخ ووحده الموت كان يبكي قسوته”، هي التي خلدته كما يستحق وبكل الحب “فنم في سلام نم نومة هنيئة ودعك من هموم هذا العالم واسترح يا أمل.
إليك أيضًا
add تابِعني remove_red_eye 1,435



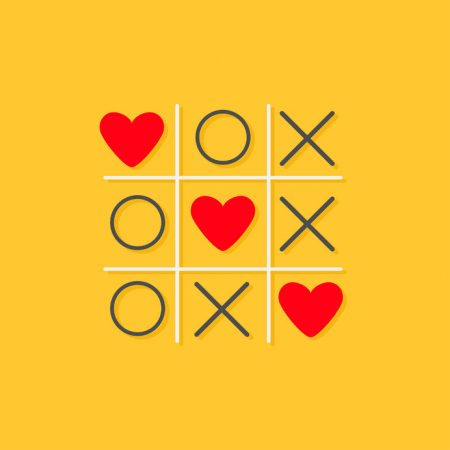






























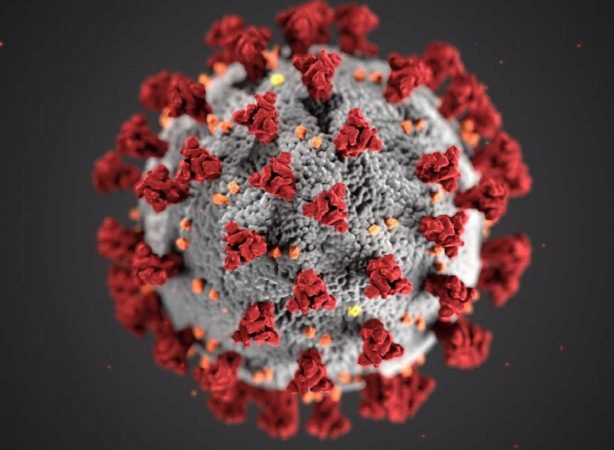

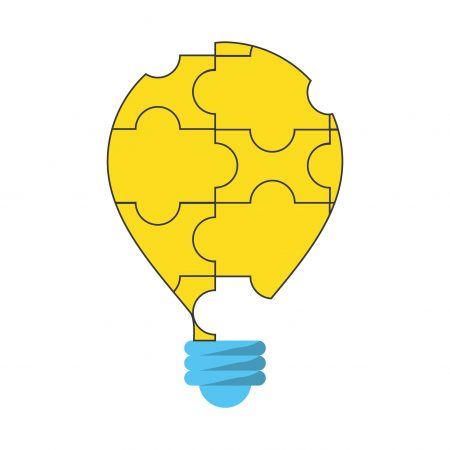






تجارب إنسانية عميقة مؤلمة ومؤثرة عن حكايات الموت والرثاء.. الحب والألم
link https://ziid.net/?p=82462