في مدح المكتب المنزلي
هنالك شعور بالألفة يزيد كل يوم بين العامل ومكان عمله، فأشياؤه وأدواته تحبه ويحبها والذكريات بينهما مشتركة، كما هو المكتب المنزلي
add تابِعني remove_red_eye 8,181
أجلس في وقت مبكر بمكاني المفضل في يوم أحد، وهو ملحقٌ خلف منزلي، على كرسيي المفضل، عمره خمسة وعشرون عاماً، متوسط الحجم من نوع آيرون عليه بضعة حروق تثقب المقعد الشبكي. على أننا في فصل الربيع، فلا يزال الجو بارداً في الخارج. أرتدي سترتي وأغطي بقبعتها رأسي، محافظاً على دفء مخي الساكن في جمجمتي. ليس لي مكان إلا هذا لأكون فيه. عقرب الثواني الأحمر بساعة المدرسة المستعملة المعلقة عالياً على الجدار يدق بصوت مسموع، حاسبة اللحظة التي تتقدم، كل لحظة أعيشها.
عبر النوافذ المتعددة، بوسعي أن أرى الشمس الي تتحرّق عبر طبقات الغيوم، كاشفة عن أجزاء زرقاء خفيفة من السماء، سأترك تحديد اللون المقصود لصديقي الفنان البصري؛ بالنسبة لي فهو لون حافل بذكريات الصبغ الذي اعتدنا على استخدامه للسماوات عندما كنت في المرحلة الابتدائية. تعبر طائرة فوقي، لامعة ومعدنية، تهدر عابرة الجو مثل البرق. في منتصف المسافة، صقر بذيل أحمر يحوّم، باحثاً في الوادي عن إفطاره؛ الطيور الطنانة ترفرف متوثبة، بغزل مصدرة زقزقتها المختلفة. نسيم يهب مجتاحا سيقان البامبو في بيت الجيران. تتمايل السيقان وتضرب بعضها، مصدرة صوتاً خشبياً كإيقاع الماريمبا الأفريقية. من جانب التلة بوسعي أن أسمع صوت محركات القوارب السريعة الأجش، قوارب مائية شخصية أخرى تترك تموجات دائرية من حول خليج قريب، أناس يعيشون أجواء نهاية الأسبوع في ذروتها.
هنا في مكتبي المنزلي، الفاصل ضبابي بين المتعة والواجب. نهاية أسبوع أو غيرها، ليس هنالك فارق بالنسبة لي. لا أحد يعد ساعات عملي. عملي هو هوايتي أيضا. تستغرق أعمالي ما وسعها أن تستغرق. ذلك لأن لا أحد يدفع لي مقابل أي وقت هو أمر ثانوي. مثل معظم الناس، أعمل لأعيش. لكنني أحيا أيضا لأعمل.
على مساحة من تسعين متراً مربعاً تحوي قبضة من عوالم محتشدة من الصور والذكريات والكتب وأشياء من التاريخ الشخصي معظمها مؤهلة لانطباق الضرائب عليها، كلها ملكي وتحت أمري في المكان الذي أقوم بعملي فيه.
ليس مثل أي مكان آخر، عندما أكون هنا فأنا أعرف من أنا.
***
الوقت الآن بعد الظهر بقليل. ولقد عدت للتو من البيت، حيث تناولت غدائي الذي يستغرق ربع ساعة تقريباً والمكون من بقايا طعام الأمس. بعد ذلك، طويت الملابس البيضاء ووضعت الملابس الملونة في النشافة.
عندما أفكر بالأمر، آتي من ثقافة تؤمن بالمكاتب المنزلية. كلا جدَيَّ وهما محامٍ وصاحب محل ملابس وأحذية كان لديهما مكاتب منزلية، ويتابعون أماكن أعمالهم التقليدية عن بعد. أتذكر وأنا صبي صغير أدور حول كراسي مكاتبهم، أطبع بأصبعين على آلالاتهم العتيقة الرفيعة. جزء مني يؤمن بأن يدين بحبي للكتابة إلى سرور هذه الأيام، انجذابي غير القابل للتفسير إلى الطباعة –ذلك الصوت المدهش الذي يشبه صوت الشقاطة لاسطوانة الآلة الكاتبة، القرع المطقطق للمفاتيح مقابل عشرين رطل الموثق، الرنة التي تحدث عند الوصول إلى نهاية السطر معلنة الحاجة للحامل أن ينظف وهو يعود. أن تطبع يعني أن تستحوذ على العالم بين أطراف أصابعك- ستة وعشرون رمزاً محايداً لا نهائية التشكّل. إنها مهمة تتطلب الدقة ورهافة الحس. عالم آخر للسيطرة عليه.
أبي كان طبيب نساء وتوليد. كان لديه مكتب منزلي، يقتصر بصرامة على الأعمال الروتينية، في قبو مزرعتنا، كان المكان الوحيد الذي يُسمح له فيه بتدخين السيجار. كانت القطعة المحورية في مكتب أبي المنزلي طاولة اشتراها له والداه ليستخدمها في كلية الطب – طاولة مصنوعة من خشب الماهوغني الأشقر بتصميم من منتصف القرن الحديث بمكان للركبتين أسفلها أدراج منحنية. أتذكر كصبي تسللي إلى أسفل المكتب عندما يغيب والدي في المساء. في الدرج العميق المزدوج على الجانب الأيسر من الطاولة، يحتفظ أبي خفية بهدايا ممتعة من أصدقائه.
أعطاني أبي هذه الطاولة والصندوق عندما التحقت بكلية الحقوق، لأسباب رمزية وعمليو على حدٍ سواء. آملاً، كما قال، أن يراني خريّجا بنفس نوعية النجاح الذي كان هو عليه.
بطبيعة الحال، فترة التحاقي بالقانون دامت ثلاثة أسابيع فحسب، لكن سُمح لي بالاحتفاظ بالأثاث، والذي سافر معي طوال أربعين سنة تجسيداً للمكتب المنزلي. في أرلينغتون فيرجينيا، كان المكتب في غرفة النوم الثانية من شقة تتموضع بالقرب من مسار طيران فيما كان يسمى المطار الوطني – كان البيت كله يهتز. في واشنطون دي سي، سكنت بشقة في قبو، ثم في دور علوي، ثم في بيت بالمدينة بأكثر من دور، لآخر اثنتي عشرة سنة. كان مكتبي بالدور الثالث؛ كان لمكتبي مكان في زاوية ضمن النافذة الأمامية، وكانت تطل على منظر للمدينة لجزء كان لم يسمَّ بعد (حالياً يسمى منطقة المسرح)، حيث كان يسرح المجرمون في زواياه المظلمة، طبيعة مختلفة لعرض يجري أداؤه طوال ساعات اليوم والليلة.
عاشت طاولة أبي الآن أكثر منه. للعشرين سنة الماضية ظلت في هذه الغرفة، في سان دييغو، في الزاوية السفلى إلى اليسار من الجزء القاري من الولايات المتحدة، خمسة وعشرون ميلاً شمال الحدود المكسكية. يمتلئ الدرج العميق بأدوات مراسل عتيقة؛ مسجلات فيديو معطوبة، كاميرات أفلام، وسائط مكتب قديمة وأدوات مكتبية أخرى، أشياء لا تشبه الأشياء التي كانت في درج أبي. في الصندوق يوجد لدي كومة أوراق ممزقة من سنوات عملي كمراسل صحفي وبضع نسخ مجلات أدبية حررتها في الكلية. لازلت أتذكر فتحها في وقت ما وأجد العديد من الكتبيات الطبية التي كان أبي يعطيها لمرضاه.
ومن أجل استيعاب أفضل للقطع المختلفة المرتبطة بمكاتب اليوم الحديثة، أضفت حول المكتب عددا من الطاولات المتنوعة والأجهزة والمنصات، لهذا فأنا تقريباً محاصر بالسطوح؛ حتى تتصور شكل مكتبي تصور شكل محل أثاث مكتبي يقوم بتصفية. (طاولة الطباعة الأولى صارت الآن تحمل طابعة ليزر بعدما كانت تحمل آلة كاتبة من آي بي إم.) أدور حولها، مدّورا كرسيي (جالساً فوق قطعة بلاستيك أرضية)، بوسعي القيام بمختلف المهام والمشاريع التي أقوم بها بالآن ذاته. في بعض الأحيان أتخيل نفسي جالساً في قمرة القيادة في سفينة فضائية، كل أزرار التحكم لمؤسستي العظيمة عند أطراف أصابعي – أنظروا هذه إشارة أخرى لمسألة التحكم.
قالب واضح يظهر هنا. أنا رجل مستقل، نعم. لكن هذا يجعلني أيضا لا أحد (نكرة). مسؤول عن ذاتي فقط. قمة الإمكانية وفقدانها في الوقت ذاته.
***
الآن في هدأة الليل، تأخذ هذه الأشياء وقتاً، وهذا سبب آخر أفترض أنه متعلق بقضائي وقتاً طويلاً في مكتبي المنزلي. السماء حالكة. النجوم ظاهرة. ومن مكان ما في الوادي تنعق بومة. لو أنصت بما يكفي فبوسعي سماع الأمواج تتحطم بهدوء على الساحل، على بعد نصف ميل من هنا.
بعدما صنعت لنفسي عشاءً بسيطاً مكوناً من لحم مشوي وخضروات، رفعت الصحون وعدت خمسين خطوة تقريباً إلى مكتبي. أمس، تركت المنزل ذاهباً إلى مكتب البريد. اليوم لم أغادر المنزل بتاتاً؛ سحابة وقتي أزجيتها على هذا الكرسي. ونعم، لا أزال مرتدياً سروالي القطني الذي ارتديته هذا الصباح عندما تدحرجت من على سريري. سأحرص على الاستحمام بنهاية الليلة. فأنا عامل بيتي لكني لست كارها للبشر.
لبضع دقائق فاتت، كنت أحاول التوصل إلى احتساب الساعات التي قضيتها تقريباً على هذا المكتب، وحيداً في غرفة مع أفكاري المضنية. مع كل ذاك السفر من أجل العمل فمن الصعب التوصل إلى إجابة، مع أني أعرف أنني أمضي وقتاً كل أسبوع في الميدان أقوم بالبحوث، لقد قضيت بصفة عامة عدداً من الأسابيع على مكتبي؛ قائماً بالاتصالات والترتيبات، مسجلاً، قائماً بأبحاث إضافية، مؤلفاً، معيداً لكتابة ومحرراً.
مُعانياً من أجل إيجاد المعادلة الصحيحة، ذهبت إلى المدخل ونظرت عبر الظُلمة، في اتجاه نعيق البومة. في أمسية صيقية ساخنة طارت البومة بقربي على بعد قدم أو قدمين؛ أخافني تحركها وصوتها وهي تتحرك.
واقفاً هناك، لاحظت أحد صور ابني العديدة. في عقد مضى، كان يحاول جاهداً ليكون قلب دفاع في كرة السلة بالمدرسة المتوسطة. في وقت كان العديد من الصبية يحلمون أن يكونوا رياضيين محترفين، كان لديه قميص فريق الليكرز باسمه مطبوعة خصيصاً له. كان يقوم بتمارين إضافية، مع مدرب، يركض لعدة أميال كل يوم.
بعد الظهر في يوم كان خارجاً للتمرين، وكنت جالساً هنا في مكتبي المنزلي، أفكر متمنياً لو أني أستطيع أن أفعل شيئاً لمساعدته. شيء واحد ستتعلمه (آمل ذلك) كوالد – كان على الفتى أن يقوم بكل تمارينه وواجباته في مادة الرياضيات بنفسه. ليس بوسعك أن تقوم بها بالنيابة عنه. كل ما بوسعك حقاً أن تقوم به هو أن تشجعهم.
في تلك اللحظة، فكرة جالت بخاطري. مشيت عبر المكتب والتقطت قلماً. وكتبت على هذا النحو:
الاجتهاد
المُمارَس بعناية
يبني رجلاً
يصنع الحياة
يوماً بعد يوماً
مع أني كتبت هذا وابني في بالي، ذات الأمر بوسعه أن يبني امرأة كذلك.
كان هذا ما تعلمته بعد أربعين سنة من الجلوس إلى مكتبي المنزلي، مختاراً فِعل ما أحب.
add تابِعني remove_red_eye 8,181



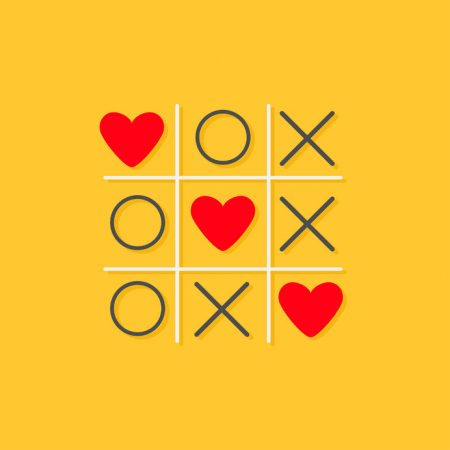






























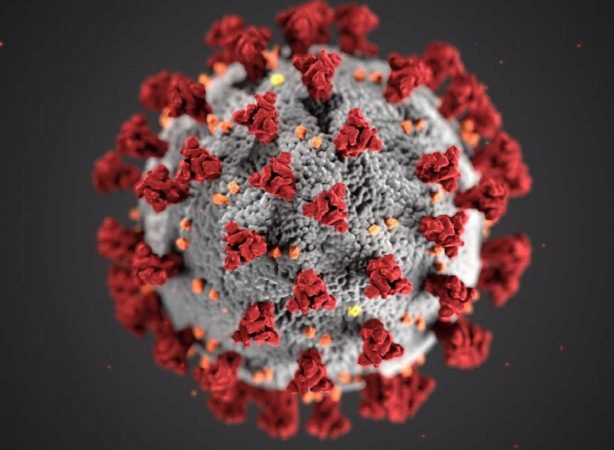

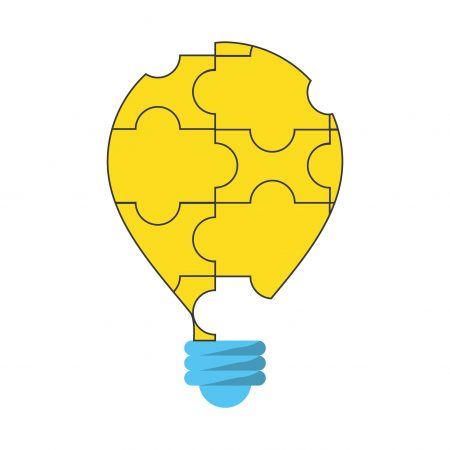






اقرأ عن علاقتي مع مكتبي المنزلي
link https://ziid.net/?p=15118